ديڤيد جرافتون: علاقة الدولة بالأقباط: نظرة للماضي قبل أن نتقدم للمستقبل
هذا المقال تم نشره بشكل رسمي بالمراجع في صيغة pdf:
ديڤيد جرافتون، “علاقة الدولة بالأقباط: نظرة للماضي قبل أن نتقدم للمستقبل،” المجلة اللاهوتية المصرية 1 (2014): 5–23.
الثورة، ما الذي حدث الآن؟
لقد كانت ثورة يناير وما تبعها من وقائع سياسية مثيرة ومحرِّكة لكل المصريين. إن صور الثوَّار وهم حاملين شعارات “عيش حرية عدالة اجتماعية” ومشاركة الشعب بكل طبقاته الاقتصادية والاجتماعية وخلفياته الدينية في ميدان التحرير سوف تعيش في ذاكرة التاريخ المصري لعدة سنوات قادمة. ومازالت الخطوات المهمة نحو مصر الجديدة يجب أن تسير في طريق غير مرسوم. فالمباحثات المتوالية بين الأحزاب المختلفة بما فيها المنظمات الإسلامية المتنوِّعة جدًا هي شاغل الكثير من المصريين، فبينما يتناظر في العلن كل الأحزاب السياسية الوطنية والليبرالية والعلمانية والإصلاحيين الإسلاميين والسلفيين والكنيسة الأرثوذكسية في موضوع شكل مصر في المستقبل فإن التساؤل عن مدى مشاركة الكنيسة القبطية الإنجيلية هو تساؤل مهم وهو: ما الدور الذي سوف يلعبه المجتمع الإنجيلي وما هي الموارد التي لدى المجتمع الإنجيلي والتي سوف يطرحها للنقاش العام والمحادثات بخصوص مستقبل المجتمع المصري والحكومة؟
اتسم الأقباط الإنجيليون بالتصوُّف من الناحية التاريخية في مجال الحياة الدينية والسياسية. وما أعنيه هنا أن الإنجيليين لم يتقدموا بمشروعات تؤدي إلى تغيير المؤسسات السياسية وذلك يرجع لأسباب دينية. هم بالتحديد كانوا في مقدمة من أسسَّوا المدارس والمستشفيات والملاجئ… إلخ. ولكن فيما يختص بالمناصرة السياسية فقد كانوا قانعين بالعمل مع الأفراد أو مع المجموعات الصغيرة. فلم يقوموا بتناول الموضوعات القومية الأكبر. كما أن الإرساليات المشيخية والأنجليكانية الأولى والتي أدى نشاطها إلى خلق مجتمعات إنجيلية مصرية محلية بالكامل كانت في الأغلب تنتمي للتَقَوية.
وركز منظور التَقَوية على خلاص المؤمن الفرد من خلال قراءة الكتاب المقدس، ففي رأيهم أن هذا كان سيؤدي بشكل طبيعي وحتمي إلى إيجاد جيل من أخلاقيات المؤمن الفرد الذي سيؤثر بدوره على المجتمع بشكل واسع. ولذا فإن وسائل الإرسالية الأمريكية والإنجليزية ركَّزت بشدة على التعليم. لم تكن هناك حاجة للانشغال بموضوعات اجتماعية أكبر باعتبار أن التقدم الطبيعي لتجديد الفرد سوف يؤدي بالضرورة إلى مجتمع أخلاقي وسلوكي. وأيضًا وكما في الإصلاح في أوروبا، لم يؤد الإصلاح الإنجيلي إلى مثل هذا التغيير في المجتمع وإنما إلى خلق جماعة جديدة وهي الإنجيليون. فالجماعة منذ أن اعترفت الإمبراطورية العثمانية بها عام 1850 هي ملَّة خاصة بالجماعة ولها قواعدها وعاداتها الخاصة.
بينما ظل الأقباط دائمًا ملتصقين بهويتهم الوطنية وشاركوا بالكامل في حكم مصر بالإضافة إلى الدفاع عنها فقد كانت هناك مناقشات قليلة توجهت للأساس اللاهوتي والكتابي للمشاركة الإنجيلية العامة في المجتمع المصري وللمجتمع المصري. ولقد حرَّكت التداعيات السياسية لثورة يناير خوف العديد من الأقباط من حكومة الإسلاميين أو السلفيين و ربما حرَّكت الأحداث المؤثرة أيضًا الإنجيليين للبحث في صفحات الكتاب المقدس عن علامات رؤيوية لنهاية التاريخ.
وعلى كل فإن السجل التاريخي يوضِّح أن الكنيسة القبطية قد واجهت الكثير من التحديات والفرص طوال تاريخها الذي يقرب من 2000 سنة وأن الوقائع الحالية لها نفس أهمية مستقبل مصر وهي فترة أخرى للدخول إلى المجال العام. وهذا المقال ليس محاولة لوضع تصور لاهوتي إنجيلي قبطي للدخول في المجال العام أو الأخلاقيات الاجتماعية وإنما بالأحرى هو يرمي إلى تحريك بعض الأفكار بخصوص الوحدة. ورجائي أن يحرِّك هذا المقال مزيدًا من الحوار للتطلُّع إلى مصر الجديدة.
(من المهم وضع ملاحظة هنا وهي أنني سوف استخدم كلمة “قبطي” للإشارة إلى التقليد المسيحي في مصر أما الصفات المحددة مثل “أرثوذكسي” و “إنجيلي” فللإشارة إلى كنائس بعينها، والإشارة العامة إلى الأقباط لا يجب أن نتخطَّاها وهذا مهم لمحاججتي بشكل عام بخصوص تاريخ الكنيسة في مصر.)
نظرة للوراء بخصوص علاقات الأقباط والدولة
ربما من المغري أن نقسِّم فترات التصادم القبطي مع الدولة إلى أربع فترات: قبل المسيحية – المسيحية – الإسلامية – والحكم العلماني الحديث. وعلى كل فإن هذا التقسيم قد يسيء تفسير المصادر التاريخية بشكل خطير وقد يساند أيديولوجيات متنوِّعة فقط. وهذا الأسلوب في التفكير قد يحدث توترًا نتيجة الإحساس بأن الفترة السياسية الحالية تهدد بنقل الأقباط من العصر الحديث إلى سجون العصور الوسطى بأن يكونوا “ذميين”. بينما من الواضح أن العالم يتجه الآن قدمًا نحو تحقيق المساواة وحقوق الإنسان للمواطنين في ظل حكومات ديمقراطية. ولكن مثل هذه الدول الديمقراطية وجُدت بالكاد. ولذا فلا يصح القول إن مجرد وجود المسيحية والحكومات العلمانية الحديثة كانت ضمانة لمنح عصور ذهبية للجماعة القبطية بينما مثَّل حكم الوثنيين الرومان والحكم الإسلامي فترات اضطهاد بالنسبة للمسيحيين. فالسرد التاريخي يوضح انه في أي من العصور يمكن أن نجد أن الأقباط قد حصلوا على فرص اقتصادية أو سياسية أو تم قمعهم بشكل عام وهذا بناء على وجهات نظر كل حاكم موجود في السلطة بغض النظر عن دوافعهم الدينية، كما أننا نجد أنه بينما يعاني جانب من المجتمع القبطي نجد أن جوانب أخرى قد تنتعش.
وتقدم مطبوعة مجلس كنائس الشرق الأوسط بعنوان “المسيحية وتاريخها في الشرق الأوسط” بعض الفصول القيِّمة “لظهور الكنائس الشرقية” التي تغطي الفترة من القرن الخامس للثامن.
ويقرر مارساويرس أسحق أن القرنين السابع والثامن بعد الفتح الإسلامي كانا فترة نهضة إدارية وروحية واجتماعية وفكرية للكنيسة السريانية.
وطبقًا للأب سمير خليل فإن قيام الإمبراطورية العباسية أعطي دورًا لمشاركة المسيحيين العرب في النهضة العربية من أمثال حنين بن أسحق، وقسطة بن لوقا بين آخرين. ولذا فإن المفهوم السائد بأن مجيء الإسلام هزم المسيحية وقهر الذميين ربما يكون إعادة قراءة معاصرة للتاريخ بناء على خبراتنا الحالية أكثر من كونها حقائق واقعية.
الحكم الروماني المبكر
في مزار القديس مرقس في العباسية يمكن للعابدين أن يروا لوحة لاستشهاد القديس مرقس في وسط حشد من الناس في الإسكندرية. ومن هذه الصورة الكبيرة يمكن أن نتحسس أن المسيحية القبطية منذ بدايتها المبكرة جدًا إلى اللحظة الحالية كانت تحت حصار المجتمع بشكل كبير. وعلى كل فإن المصادر التاريخية تبدو أنها تشير إلى أن المسيحية المبكرة نمت في ظلال مجتمع تعددي تسامح فيه الحاكم الروماني مع العديد من الفرق والجماعات السرية والدينية. بينما كان المسيحيون في آسيا الصغرى يتخوَّفون من اضطهاد وقتي على يد السلطات الرومانية وحسبما نجد في خطابات بليني Pliny إلى تراجان Trajan كانت مصر في حالة مختلفة تمامًا. فعندما أتى الرومان إلى مصر في 31 ق.م، فقد واجهوا البانثيوم المصري الكبير وأيضًا جماعة يهودية متأصلة تمامًا. وهذا الجو سمح للمسيحيين بتدبير أمورهم والانتشار في جو من المشاكل القليلة على يد الدولة. وقبل كل شيء فقد قال بولس: “وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الإِيمَانِ فَاقْبَلُوهُ لاَ لِمُحَاكَمَةِ الأَفْكَارِ. وَاحِدٌ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَمَّا الضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولاً. لاَ يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لاَ يَأْكُلُ وَلاَ يَدِنْ مَنْ لاَ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ – لأَنَّ اللهَ قَبِلَهُ. مَنْ أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ؟ هُوَ لِمَوْلاَهُ يَثْبُتُ أَوْ يَسْقُطُ. وَلَكِنَّهُ سَيُثَبَّتُ لأَنَّ اللهَ قَادِرٌ أَنْ يُثَبِّتَهُ. وَاحِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْماً دُونَ يَوْمٍ وَآخَرُ يَعْتَبِرُ كُلَّ يَوْمٍ – فَلْيَتَيَقَّنْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ: الَّذِي يَهْتَمُّ بِالْيَوْمِ فَلِلرَّبِّ يَهْتَمُّ وَالَّذِي لاَ يَهْتَمُّ بِالْيَوْمِ فَلِلرَّبِّ لاَ يَهْتَمُّ. وَالَّذِي يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لأَنَّهُ يَشْكُرُ اللهَ وَالَّذِي لاَ يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لاَ يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ اللهَ. لأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلاَ أَحَدٌ يَمُوتُ لِذَاتِهِ” (رومية 13: 1–7). وبينما قال أكليمندس Clementإن على المسيحيين أن يطلبوا البركات للحكام الرومان (1أكليمندس 63: 1) وهذه التعددية الدينية كانت واضحة أيضًا بين الجماعة المسيحية فأغلب الدارسين يوافقون على أن مخطوطات نجع حمادي المعروضة الآن في المتحف القبطي توضح أن المسيحيين تمسَّكوا بمواقف لاهوتية وكنسية متباينة.
عصر الشهداء
لم يبدأ الرومان النظر إلى اليهود وبالتالي المسيحيين باعتبارهم خطرًا على الإمبراطورية إلا بعد تمرُّد باركوكبا عام 135م. لقد كان القرن الثاني فترة صعبة للمسيحيين في الإمبراطورية الرومانية. فلقد أمد الإمبراطور فيليب العرب المسيحيين بإحسان ربما نتيجة للتعامل مع المسيحيين في سوريا بينما لم يكن خليفته كريمًا. أُعلن ديسيوس Decius إمبراطورًا في الإسكندرية عام 249، وفي الحال أمر كل الرومان لتقديم ذبائح للآلهة. وذكر البطريرك القبطي ديونيسيوس Dionysius قصصًا عن الغوغاء وهم يقتلون المسيحيين في الشوارع ويجبرونهم على إنكار إيمانهم. وهذا لسوء الحظ كان مجرد بداية فالإمبراطور التالي فاليران اضطهد المسيحيين وعلى كلٍ ففي عام 303 شن الإمبراطور دقلديانوس الاضطهاد الكبير. ُقتل المسيحيون وأُحرقت الكنائس وحُرمت الكتب المقدسة وهذه هي الفترة التي عُرفت “بعصر الشهداء” وهي الفترة التي تركت علامتها الدائمة على الكنيسة القبطية، فمن تلك الفترة ظهر العديد من القديسين الأرثوذكس وهي أيضًا الفترة التي بدأ فيها تسجيل التقويم القبطي، فمنذ بداية حكم دقلديانوس ترسَّخت فكرة أن الكنيسة القبطية بُنيت على دماء الشهداء.
الإمبراطورية المسيحية
لم يكن مرسوم قسطنطين 313 م يمثِّل ضغطًا كبيرًا على الإيمان المسيحي في الإمبراطورية كاعتراف إمبراطوري بحق الوجود للمسيحية جنبًا إلى جنب مع الأديان القديمة. ويشير علم الآثار القديم المتأخر إلى ممارسة مستمرة للديانات التقليدية والكهنوت المصري جنبًا إلى جنب مع اليهودية والمسيحية. وكان الإمبراطور ثيوديوس Theodosius هو الذي أعلن أن غير المسيحيين مجانين ويستحقون عقابًا إمبراطوريًا.
وفي بواكير القرن الخامس نجد أن العنف بدأ يُرتكب ضد الديانات المصرية القديمة على يد الكهنوت القبطي والرهبان. فقد ذكر المؤرخان الكنسيان روفنس Rufinus وسوزومن Sozomen تدمير البطريرك ثاوفيلس للسيرابيوم في الإسكندرية عام 391 (ضد إرادة الإمبراطور) وترأّس كيرلس خليفة ثاوفيلس عملية قتل الفيلسوفة الوثنية هيباشيا عام 415. كما طرد اليهود من الإسكندرية وكانت له عدة مجادلات مع الحاكم الروماني أوريستسOrestes. لذلك فطوال القرن الرابع وبواكير القرن الخامس نجد حركة عنف متصاعدة “لمسحنة” البلاد بينما ظلت الحكومة متمسِّكة بسياسة منفتحة للتسامح تجاه هذه الأديان. في عام 529 أغلق الإمبراطور جستنيان كل المعابد الأغريقية الرومانية والفرعونية وطارد كل الأديان عدا المسيحية. كما سجل آلان دسليور Alain Ducellier أن الكنيسة في الإمبراطورية البيزنطية الجديدة ثبَّتت المؤسسة الاجتماعية والإدارية الإمبراطورية وأرست نظمها الخاصة بها على نمط الأجهزة التي وضعتها الدولة. وصار الأساقفة والكهنة واقعيًا موظفين مدينيين وإداريين. وكانت كلاً من الكنيسة والدولة وجهان لعملة واحدة. ولكن كما كتب أثناسيوس للإمبراطور أوسيوس Ossius “إليك أعطى الله الإمبراطورية كما أعطاها لنا وهو ضمن شئون الكنيسة”.
الانقسام الخلقيدوني ونمو كنيسة مصرية وطنية
قيل أنه طوال الجدالات الكريستولوجية للقرن الرابع والخامس إن الكنيسة العربية بدأت تنسحب من السيطرة البيزنطية لتكون حركة وطنية واحتجاجية ضد السلطات الأجنبية.
ويزخر التاريخ الشرقي والقبطي بإدانة الاضطهاد البيزنطي وكان الحد الفاصل بالطبع هو مجمع خلقيدونية حين حاول الإمبراطور مارسيانMarcian توحيد الكنيسة العالمية تحت لواء إمبراطورية واحدة. وعلى كل فهذا نتج عنه الانقسام الأول الرئيسي للكنيسة حيث رفض الأساقفة المصريون والسريانيون والأرمينيون الاعتراف بالصيغة اليونانية “طبيعتان للمسيح” ولم تكن عدم موافقتهم بخصوص مفهوم الإلهي والإنساني للمسيح ولكن بسبب العبارات اليونانية المفروضة والمُملاة من قسطنطين. وبسبب رفض الكنيسة القبطية لقبول صيغة الإيمان الرسمية الخلقيدونية فقد عاشت ما يقرب من مئتي عام تحت الاضطهاد البيزنطي والتمييز وإلى حد ما الاستشهاد. وأطلق ستيفن ديفيز Stephen Davis على هذا الوضع “الاستعمار الكنسي” حيث سعى السلطان الكنسي لفرض وجهة نظره السلطوية على المصريين. وصل هذا الانشقاق إلى مرحلة حرجة عندما عيَّن الإمبراطور هرقل كيرلس أسقفًا للإسكندرية عام 630. وواقعيًا قام كيرلس بالدور الرئاسي الكنسي والسياسى للإمبراطور في الإسكندرية وأقمع الكهنة الأقباط والأساقفة بعنف الذين رفضوا الاعتراف بالصيغة الخلقيدونية ثم نفى البطريرك القبطي المحبوب بنيامين.
الفتح العربي الإسلامي
هناك الكثير مما كُتب ونوقش بخصوص الفتح الإسلامي لمصر، وهناك عدة وجهات نظر تم التعبير عنها كثيرًا في ظل السياق الحالي لتوترات الظهور السلفي. بينما لا يوجد شك أن المسلمين العرب فتحوا مصر عسكريًا فإن مجيئهم يشهد عدم اختلاف عن أي إمبراطورية أخرى فتحت مصر على مر القرون. ففي الواقع أوضح تأسيس الفسطاط كمعسكر عربي مسلم منفصل شمال حصن بابليون أن السياسة المبكرة للمسلمين كانت قانعة بمجرد الاحتلال والاستفادة من المصادر الغنية لوادي نهر النيل المصري أكثر من الرغبة في فرض الشريعة الإسلامية وهو التوجه الذي لم يبدأ في اتخاذ جذور له في مصر إلا بعد مجيء الشافعي في القرن التاسع.
تنظر العديد من المصادر القبطية إلى هذه الفترة باعتبارها عقابًا للبيزنطيين على اضطهادهم وهرطقتهم ضد الكنيسة الحقيقية. في القرن السابع لاحظ الأسقف جون أسقف نيقو John of Nikou “هذا الطرد (للبيزنطيين) ونصر المسلمين يعود على شر الإمبراطور هرقل واضطهاده للأرثوذكس (الأقباط).” وبالمثل في القرن العاشر ورد في “تاريخ البطاركة” أن الرب ترك جيش الروم البيزنطيين كعقاب على إيمانهم الفاسد. واختلف الدارسون حول تأييد الأقباط ومساعدتهم للعرب المسيحيين في غزوهم للبيزنطيين في مصر لأن المصادر تورد في الواقع صورة معقَّدة.
ولكن الواضح أن هناك انقسامًا عميقًا بين الأقباط والبيزنطيين أدى إلى مناخ يوفِّر للعرب المسلمين أن يحكموا السيطرة على مصر بسهولة. وكان الأقباط غير الخلقدونيين قلقين جدًا نتيجة لهزيمة البيزنطيين وأكثر الأمثلة أهمية بالنسبة لوجهة النظر القبطية الرسمية هي القصة المعروفة عن عمرو بن العاص والبطريرك بنيامين.
فبعد هزيمة البطريرك البيزنطي والقائد قورس (المقوقس) Cyrus وتراجعهما إلى القسطنطينية دعا عمرو البطريرك القبطي بنيامين الذي كان مختفيًا لأكثر من عشر سنوات ودعاه ليتولى كرسيه البابوي في الإسكندرية. وكما تُروى القصة في “تاريخ البطاركة” طلب عمرو البركة من بنيامين ليبارك تقدم العرب المسلمين إلى شمال أفريقيا:
“أستأنف كل سلطاتك على كل كنائسك وعلى شعبك وقم بإدارة شئونها وإذا صليت من أجلي وطلبت أن أذهب إلى الغرب إلى بنتابوليس Pentapolis وأملك عليهم كما في مصر وعدت إليك سالمًا وسريعًا فسوف أعطيك كل ما تطلبه مني” ثم صلى المبارك بنيامين لعمرو ونطق بحديث بليغ مما جعل عمرو ومن حضروا معه يعجب بالبطريرك وهو حديث تضمَّن كلمات تشجيع وفائدة عظيمة لمن سمعوه وقد كشف بعض الأمور لعمرو وغادر من حضرته مكرَّمًا ومبجلاً.
وفيما إذا كان هذا السرد حقيقة واقعة أم شيء أُدخل فيما بعد فهذا لا يهم هنا. فالحاكم العربي الأول كان راضيًا بالسماح للأقباط بالاحتفاظ بمؤسساتهم الدينية والمدنية فالإدارة والتنظيم والضرائب… الخ، كانت كلها في يد الأقباط وصار البطريرك القبطي هو الإداري المدني في الواقع لحكومة أجنبية والمسئول عن الشئون الداخلية للمصريين بينما حصل العرب على الضرائب الكثيرة والتقدمات من وادي النيل الغني ليتم توزيعها بطول الإمبراطورية الإسلامية. ولا نجد مرجعًا للاتفاقية العمرية خلال هذه الفترة وما هو موجود هو اتفاقية معروفة بخصوص العلاقات بين القوى الأجنبية والدولة التابعة.
وكما ذكر عزيز عطية أن العلاقات بين الأقباط والعرب قد تأسست بشكل ملحوظ على الريع والضريبة. ولكن إذا اعتبرت العلاقات العربية القبطية المبكرة لا تختلف عن أي مستعمرين لمصر فإن المسلمين العرب سوف يبدأون في التغير في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن.
تعريب وأسلمة مصر
بدأ الخليفة الأموي عبد الملك تعريب الإمبراطورية الإسلامية معلنًا أن كل الإدارة يجب أن تجري باللغة العربية ومع أن هذا لم يحدث في الحال لكن العملية بدأت بالتدريج. وكانت العملة فقط هي التي تُسك بفن الخط العربي من القرآن. والنتيجة كانت زيادة السيطرة المركزية لفرض الضرائب عن طريق العرب المسلمين. وفي الواقع صار الرهبان ملزمين بدفع الضرائب بعد أن كانوا معفين منها. دفع ثقل الضريبة على الأقباط إلى تغيير ديانتهم إلى الإسلام.
وبينما يعتبر “تاريخ الآباء” خلع الأمويين على يد العباسيين عام 750 باعتباره صبر الله “للانتقام منهم” فإن الأقباط سريعًا ما أدركوا أن الحكم العباسي سوف يواصل نفس عملية فرض الضرائب الثقيلة. كان الحمل أثقل من أن يُحتمل وفي عام 831 ثار المصريون في الدلتا وهي ثورة البشمرك Bashmuric وهذه الثورة قُمعت بقسوة وبينما كان المسيحيون في العراق يلقون معاملة حسنة في ظل الحكم العباسي فإن الأقباط كانوا يعانون.
من المهم أن نتذكَّر أن المسلمين المصريين أنفسهم واجهوا أيضًا أحمال الضرائب الثقيلة واستبداد الحكَّام العشوائي من دمشق أولاً ثم من بغداد. وبدأ غالبية الأقباط يتحولون إلى الإسلام أثناء منتصف القرن التاسع إلى العاشر الذي شهد التحوُّل بناء على ثلاثة أسباب: (1) التخلَّص من مزيد من الضرائب التي كانت تُفرض على الأقباط باعتبارهم ذميين. (2) الموظفون الذين أرادوا أن يحرزوا تقدمًا في وظائفهم كان التحوُّل للإسلام مفيدًا لهم للغاية. أما أهم سبب فهو (3) الثقافة السائدة: أوجد التحوُّل إلى الإسلام فرصة للمشاركة في الثقافة السائدة أو المحلية. لقد كانت موجة مد لم يكن لها أن تتوقف.
في عام 850 أصدر الخليفة العباسي المتوكل مرسوماً سيء السمعة يمنع الأقباط من الخدمة في الحكومة. ويذكِّرنا ذلك المرسوم بأن الأقباط كان لهم سيطرة بارزة في شئون الإدارة اليومية في الحكومة في منتصف القرن التاسع وهناك علامة مهمة تشير إلى أن التحوُّل من الثقافة المسيحية إلى العربية الإسلامية تدل على أن إعلان ذلك المرسوم لم يحدث أن طُبِّق بالكامل قط واستمر الأقباط في العمل في الحكومة.
الحكم الفاطمي 969– 1147
وبعيدًا عن فترة الاضطهاد الصارخ أثناء حكم الخليفة الحاكم (996– 1020) الذي وضع قيودًا ثقيلة ليس على الأقباط فقط ولكن على المسلمين أيضًا خاصة النساء فإن احتلال مصر على يد الفاطميين شهد أكثر الفترات استعادة للأقباط تحت الحكم الإسلامي ومن الصحيح أن الحاكم قد قام بتدمير العديد من الكنائس في مصر بالإضافة إلى الضريح اليهودي المقدس بادءًا الحملات الصليبية؛ فإن المؤرخ المصري المقريزي ذكر أن العديد من الأقباط قد تحوَّلوا إلى الإسلام أثناء اضطهاد الحاكم. وعلى كلٍ فإن عصر الفاطميين كان فترة علاقات جيدة بين المسلمين والمسيحيين. وكما ذكر حنا جرجس وفيفيان فؤاد فإن الأقباط شاركوا في أعلى درجات الإدارة في الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكر (تاريخ البطاركة) بناء الكنائس الممتد في هذه الفترة وبالطبع كانت فترة الخليفة الحاكم استثناء من ذلك. وذُكرت المعجزة الكبرى الخاصة بنقل جبل المقطم بأنها حدثت أثناء تلك الفترة تحت حكم المعز لدين الله (932–975). ومما لا يُذكر كثيرًا بخصوص رواية هذه المعجزة أن أصل الواقعة يدور حول مقابلة حوارية بين الخليفة المعز لدين الله ووزيره يعقوب بن فلتس الذي تحوَّل من اليهودية والمؤلف الأصلي لتاريخ البطاركة ساويرس بن المقفع. كان الحوار ملمحًا عامًا لحياة البلاط مميزِّا المواجهة بين اليهود والمسيحيين والمسلمين بالإضافة إلى المواجهات الاقتصادية اليومية. وأهم دراسة دارت حول سجلات اليهودية الوسيطة وُجدت في مجمع بن عزرا في مصر القديمة التي قام بها شلومو جوتين Shelom Gotein وتوضح تفاعل المجتمع اليهودي مع السكان المسلمين في مصر القديمة والفسطاط.
كانت المواجهة الشهيرة بين الأقباط المصريين واليهود والمسلمين على كل مستويات المجتمع بما فيها الحكومة نتيجة عوامل عدة.
أولاً: المذهب الإسماعيلي الشيعي كان أقلية وسط أغلبية سنيِّة. وأوجد الحكم الإسماعيلي انفتاحًا غذى التعددية. وبالطبع ظل الخليفة مسلمًا والحكم إسلاميًا ولكن أهل الذمة شاركوا في الثقافة العربية الإسلامية العالمية.
ثانيًا: بسبب سيادة الثقافة العربية الإسلامية فقد صار صعبًا على الأقباط أن يحافظوا على الانفصال بهويتهم الثقافية. وفي هذه الفترة حدثت موجة كبيرة أخرى من تحول الأقباط للإسلام. فأغلبية الأقباط لم يكونوا يحسنون القراءة أو فهم اللغة القبطية وواجهت الكنائس واقع سيادة الثقافة العربية الإسلامية حيث كانوا يعيشون. فقد أوعز البطريرك جبرائيل بن ترياق (1131–1145) باستخدام اللغة العربية في بعض أجزاء من القداس القبطي حتى يمكن فهم الإنجيل باللغة السائدة، ولذا وضع البطريرك بشكل رسمي تعريب الأقباط الذي كان قد بدأ بالفعل على يد عبد الملك في بداية القرن الثامن. وعلى كل فإن هذا التغيير أقر رسميًا وضعًا قائمًا بالفعل، وتبنَّى الأقباط اللغة العربية والثقافة في القرن الثاني عشر وظهر هذا التغيير في نمو الأدب القبطي العربي وأشهره على سبيل المثال كتاب “تاريخ البطاركة”.
الأيوبيون 1171–1250
تميَّزت الحقبة الأيوبية بعدم الاستقرار بالنسبة للأقباط حيث أحاط بهم كلٌّ من حكامهم المسلمين وغزاتهم الكاثوليك اللاتين في الحروب الصليبية. وأُتهم الأقباط كثيرًا بمساعدة الحملات الصليبية وواجهوا الاضطهاد والقمع مع أن الأقباط ساعدوا في الدفاع عن دمياط عام 1218، وذكر فرح فرزليFarah Firzli بوضوح الصعوبات التي واجهها المسيحيون الشرق أوسطيون نتيجة الغزوات اللاتينية. وعلى كل فقد واجه صلاح الدين أعظم التحديات الضاغطة في تطهير مصر من التأثير الشيعي على الإسلام. فأغلق الأزهر الذي كان حتى تلك اللحظة مركز التعليم الإسماعيلي وأعاد فتحه كمركز سني مهم للتعليم والذي هو قائم حتى الآن. هناك واقعة مهمة حدثت في تلك الفترة وهي أن البطريرك كريستودولوس Christodoulos (1046–1077) نقل الكرسي البابوي من الإسكندرية إلى القاهرة ليحظى بطريقة أسهل للتواصل مع الحاكم المسلم في الإشراف على شئون المجتمع القبطي. حيث بدأ الفقهاء السنيون في وضع مفاهيم أوسع للذمة أثناء تلك الفترة وكان إلزاميًا على ممثل المجتمع القبطي أن يدافع عن جماعته.
كانت الصعوبات التي واجهت الأقباط أثناء فترة الحكم الأيوبي نتيجة لمسائل داخلية. فلمدة عشرين سنة (1216–1235) ومرة أخرى من (1243–1250) لم يكن هناك بطريرك يمثِّل الأقباط عند السلطان. وعندما تم اختيار ابن لقلق كان ذلك الاختيار محل جدل فإن بابويته تميَّزت بالجدل من بدايتها. فكان انتخابه محل جدال وتشير بعض المصادر أن تعيينه تم على يد الملك الكامل وعُرفت الجدالات التي جرت أثناء بابوية ابن لقلق عند المسلمين بالفتنة ووصلت المشكلة مباشرة إلى بلاط السلطان حيث أُهين البطريرك ومات بعد ذلك بوقت قصير. ومع كل الصعوبات السياسية التي حلَّت في القرن الثالث عشر فإن ذلك الوقت كان عصرًا ذهبيًا في الثقافة القبطية. فقد اكتشف الأثريون والأبحاث التاريخية نهضة الفن القبطي ورعاية رجال أعمال وقادة أقباط لهم. ربما كان هذا نتيجة زيادة التجارة مع الدول المحاذية لشرق البحر المتوسط راجعًا إلى الحكم الأيوبي لمصر وسوريا. وبالإضافة لذلك ذكر جورج جراف Georg Graf العدد المتزايد من الكُتَّاب الأقباط في هذه الفترة. وتضم هذه القائمة عائلة أولاد العسال وهم على مستوى عالٍ من الشهرة في حد ذاتهم، وأيضًا تضم واحدًا من أكثر الوعَّاظ إنتاجًا وخصبًا في التاريخ القبطي وهو بولس البوشي. ونعرف من هذه الفترة أنه بالرغم من احتواء النصوص على تاريخ رسمي بشكل أساسي فإن وقائع الحياة اليومية تعكس شيئًا مختلفًا تمامًا. ونفس الشيء يمكن أن يُقال بخصوص كتابات الفقهاء المسلمين فبينما هم يكتبون مفاهيم صارمة عن الذمة فإن الممارسة الاجتماعية الفعلية قد تكون مختلفة بناء على هوى أو وجهات نظر الحاكم.
المماليك 1250–1517
وبالعودة للقرن الخامس عشر فإنه طبقًا المؤرخ العربي المقريزي فإن فترة المماليك تميَّزت “بإنهيار المسيحيين”. بينما كان حكم القادة الحربيين الذين يمارسون سلطات مدنية للأتراك أو سلالة وسط آسيا أدت إلى واحد من أكثر العصور أهمية في البناء منذ الحقبة الفرعونية؛ لكنها كانت فترة ضعيفة بالنسبة لتاريخ الأقباط. وأغلب الذكريات التاريخية عن وحول الأحياء القديمة في مصر ترجع إلى هذه الفترة بما فيها الممر التذكاري الذي سهَّل نمو القاهرة كقوة عظمى حربية واقتصادية. وعلى كلٍ وكما في كل الحالات أثناء هذه الفترات من القوة فإن المصري العادي شعر بلهيب الحكم التعسفي العشوائي، وكان الأقباط على الخصوص موضع اضطهاد. وتتسم الفترة المملوكية بتدمير الكنائس والعديد من أعمال الشغب والعنف المتقطِّع ضد الأقباط وبينما لم يضطهد الحكام المماليك الأقباط فإن الأحوال الاجتماعية المتدهورة إلى هذا المستوى الضعيف جعلتهم كبش الفداء لتدهور الرعية. بالإضافة لاستبداد حكم السلاطين فإن مصر عانت من مخاوف الغزو المغولي من بلاد الشام والعديد من فترات الجفاف والزلازل وأعظمها وباء الطاعون.[35]
وأثناء هذه الفترة وصل أدب الرد على أهل الذمة إلى أعلى مستوى بين الفقهاء المسلمين وبدأ العلماء المسلمون بمن فيهم ابن تيمية وابن قيم الجوزية في كتابة ما شعروا بأنه قيود مهمة على الذمي التي لم يتم الالتزام بها على يد الحكام المسلمين السابقين، وفي وقت عدم اليقينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية فإن هؤلاء الكتاب سعوا إلى إيصال المجتمع السني إلى جذوره النقية كما تصوروه هم.
الحكم العثماني 1517–1801
لم يكن الحكام العثمانيون مختلفون بأي حال عن الحكام المماليك فقد كانوا أجانب احتلوا مصر وكانوا يتشاركون في القليل مع المصريين، وعلى كلٍ فقد شهد القرنان السادس عشر والسابع عشر ازدهار الحالة الاقتصادية حيث اشترك العثمانيون في التجارة مع أوروبا، و نتج عن هذا ارتفاع مستوى المعيشة ومزيدًا من الاستقرار الاجتماعي. واستفاد الأقباط من التجارة الدولية إذ عمل الأقباط كوسطاء للتجارة في فينيسيا وفرنسا ودول أخرى. وذكر سمير مرقس أهمية عمل الأقباط كتجار وملاك أراضٍ وموظفين حكوميين في مجال الجباية. يُعزي التواصل بشكل كبير بين أوروبا ومصر في ذلك الوقت إلى نشاط الإرسالية الكاثوليكية اللاتينية خاصة الدومينيكان والكابوشيين.
الدولة المصرية الحديثة أيام محمد علي 1805–1952
عندما استخلص محمد علي مصر من السيطرة المباشرة للإمبراطورية العثمانية بدأ حركة نحو الدولة الحديثة. أرسل محمد علي الموظفين المدنيين الشباب للدراسة في أوروبا نتيجة لافتتانه بالثقافة الفرنسية والفرص المواتية، وكانت فرنسا قد احتلت مصر من (1798–1801). عادت البعثات وبدأت التأسيس وهذه الإصلاحات التي سبقت التنظيمات العثمانية عملت مع قرارات السيادة العثمانية عام 1839 و1856 بالإضافة إلى إلغاء الجزية عام 1855. وهذه القرارات الرسمية ألغت وضع الذمة والملِّة وأكدت على مساواة المسيحيين والمسلمين أمام القانون المدني. وبالطبع لم تلغ الإعلانات الرسمية التمييز ولكن وضعت مقياسًا جديدًا من المواطنة في الدولة.
استمرت المجادلة إلى هذا الوقت بخصوص من هو مسئول عن النهضة في مصر في القرن التاسع عشر. وجادل الأقباط الأرثوذكس بأن كيرلس الرابع “أبو الإصلاح” قد سبق الإنجيليين في إخراج المسيحيين من الظلام. وأشار الأقباط الأرثوذكس أيضًا إلى إصلاح المجلس الملِّي في 1874. وكان بطرس غالي أحد أعضاء المجلس الذي سوف يكون رئيس وزراء مصر. أهمية المجلس كمجلس قيادي للقادة الأقباط الأرثوذكس العلمانيين أدى بالضرورة إلى تأسيس حركة مدارس الأحد على يد حبيب جرجس عام 1918 وقد كانت حركة أساسية لاستمرارية النهضة القبطية الأرثوذكسية التي تأسست على يد كيرلس الرابع واستمرت حتى شنودة الثالث.
وبالتأكيد تتمسَّك الإرساليات الإنجليكانية والمشيخية بأن مدارس الإرساليات هي التي أسهمت في حركة الاستنارة في مصر. وكان من أهداف الإرساليات نهضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المتردِّية. وكما ذُكر سابقًا ركزت الإرساليات الإنجيلية على تطوير نظام المدارس في عرض البلاد. ولا يمكن الإقلال من أهمية مدارس أسيوط والإسكندرية والقاهرة وطنطا ضمن مدارس أخرى بالنظر لتأثيرها في رفع مستوى معيشة المصريين خاصة المرأة المصرية. وذكر أديب نجيب سلامة أيضًا أهمية العمل الصحي والتنمية التي قام بها الإنجيليون ومن الأشياء المهم ذكرها تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وبالطبع لابد أن نعطي دور محمد على أهميةً في نهضة مصر من خلال إصلاحاته الحكومية فقد أسس أول مطبعة في بولاق لطبع الأفكار الجديدة التي عاد بها موظفوه المدنيون الشباب من أوروبا. وبغض النظر عمن يكون الأول في دفع حركة تطور الدولة الحديثة بناء على المؤسسية والمساواة في المواطنة فإن ما يمكن إيضاحه أن المصريين من كل التوجهات المختلفة أسهموا في ذلك.
ولا يمكن الكلام عن الدولة الحديثة في مصر بدون ذكر الاستعمار البريطاني من (1882–1956)، بالطبع فبعدة طرق كان الاستعمار البريطاني خطوة للخلف بالنسبة لعلاقات الأقباط والمسلمين. فبينما عمل الاستعمار البريطاني بجهد لتفعيل الدولة العلمانية الحديثة التي لم تنظر للرعايا المصريين من منظور مسلم أو مسيحي ولكن كمواطنين، فإن سياستها زادت من مشكلة الهويات الدينية. وتعتبر مؤتمرات الأقباط والمسلمين عام 1911 مثالاً واضحًا على التعبير الحديث عن الهوية كرد على ضغوط الاحتلال والحكومات المقنَّعة. وآل الحال إلى أن كل من الأقباط والمسلمين اتحدوا معًا أثناء ثورة 1919 واستمروا يعملون معًا لتكوين أحزاب وطنية وسياسية. ولا يجب إغفال أن قيام حركة الأخوان المسلمين قد حدثت أثناء فترة الاحتلال البريطاني وكانت ردًا على تغيير المناخ الثقافي والسياسي لمصر.
الدولة القومية الحديثة 1953–؟
منذ عام 1952 حكمت مصر حكومة قوية ذات توجهات قومية عربية. وقد وضع هذا النظام المصري نوعًا من الاستقرار مع وجود نوع من البناء الأمني الفظ. وإذ نخفض مستوى المعيشة نتيجة لسياسة الانفتاح واستمرار الفجوة بين الأغنياء والفقراء وارتفاع نسبة الأمية لدرجة تنذر بالخطر منذ السبعينيات؛ فإن كل جماعة دينية سواء سنيِّة إسلامية أو قبطية أرثوذكسية أو قبطية كاثوليكية أو قبطية إنجيلية بدأت تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية وتعليمية كلُ إلى جماعته، حيث رأوا فشل الحكومة في دورها. فقد تدخَّلوا في تقديم خدمات لمجتمعاتهم على حساب الهوية القومية الأوسع. وعمل هذا على تفاقم الانقسام بين الجماعات.
وطوال هذا المقال رأينا كيف أن المجتمع القبطي عانى من تقلُّب سيطرة محلية أو أجنبية بالإضافة إلى الاستفادة من الحكم المحلي والأجنبي. وطوال تاريخ الأقباط فقد عانوا من اضطهاد الوثنيين والإمبراطوريات المسيحية بالإضافة إلى الأنظمة الإسلامية والقومية المحلية. من المهم ذكر أنه بينما تسود الثقافة الإسلامية مصر الآن فإن تاريخها وتطورها لم يكن مباشرًا وتلقائيًا. إن الأغلبية القبطية عاشت تحت الحكم الإسلامي ولكنها سادت من الناحية الثقافية لمدة تقرب من 300 حتى بعد مجيء العرب. ولم يحدث قبل منتصف القرن العاشر أن بدأ الأقباط يتحوَّلون إلى الإسلام لأسباب اقتصادية بالإضافة لأسباب ثقافية. ولكن أصعب الفترات للأقباط لم تحدث تحت التقوية الإسلامية ولكن تحت الدهاء الميكافيللي للحكام الأجانب. فأثناء الحكم المملوكي عانت الكنيسة استبدادًا عشوائيًا ، إلا أن هذا ما حدث مع المسلمين أيضاً. ومن المفيد أن نتذكر أنه بينما يميل الحوار السلفي السياسي الحالي إلى التركيز على كيفية وضع الشريعة فإن الحكم الإسلامي السياسي يقوم على حكام يسعون إلى الإفتاء لتدعيم قراراتهم. لقد عمل الفقهاء كمستشارين مستقلين للسلطان أثناء الحكم الإسلامي الكلاسيكي في القرون الوسطى. ولكن كان الحاكم دائما هو الذي يقرر أي من القوانين التي ستوضع موضع التطبيق.
إن مجئ محمد علي في بداية القرن التاسع عشر أنعش الحركة البطيئة والثابتة نحو الأفكار الحديثة للمدنية والدولة. وقد نظر لهذا التطور للدولة الحديثة تحت حكم محمد علي الذي اندمج في المجتمع المصري الحديث كأفكار أجنبية أو حلول (مستوردة) عند البعض. وبالطبع فإن تاريخ الإسلام يهتم بأن الكثير من الحكم الإسلامي نفسه كان هو نفسه غير مصري لكلٍ من الحكام المسلمين والفقهاء وفي بعض الحالات كان ضد ما هو مصري. كثيرًا ما أوضحت الخطابات العامة للحكام والفقهاء الإسلاميين فهمهم لمكانة ودور الذمة. ولكن الحقيقة على أرض الواقع كانت مختلفة كثيرًا. والحقيقة في بساطتها أن الخلفاء المسلمين والسلاطين واصلوا منع خدمة الأقباط في الحكومة هي مؤشر إلى أن المنع لم يحدث قط بشكل منتظم أو بأسلوب رسمي. وعلى العكس ظل الأقباط جزءًا لا غنى عنه في الحكومة المصرية حتى في السلك العسكري.
نظرة للمستقبل
تغيَّرت النظرة الإنجيلية لعلاقة الكنيسة بالدولة كثيرًا منذ وقت الإصلاح في أوروبا في القرن السادس عشر. و كان التجاوب الأولي بالنسبة للأقباط الإنجيليين هو تشجيع ومساندة روحانيات الجماعة ذات التأثير الإيجابي على وجود الفرد وأيضًا كشهادة نحو منافع الاستنارة الروحية وواقع الحياة. فكونها الجماعة الأصغر والأحدث في مصر فلم يكن أمامها اختيار آخر. وبناء على ذلك فهذا يعني أنه بغض النظر عن نظام الحكم في مصر فإن الأقباط الإنجيليين يجب أن يوفقوا وضعهم كأقلية ودورهم كخميرة للتجديد الاجتماعي والأخلاقي بطريقة إيجابية تعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وربما حتى سياسيًا.
هذه النظرة المختصرة يجب أن تذكِّرنا بأن على قدر عظمة ثورة يناير، بغض النظر عن إقامة نظام مصري جديد، فإنها خبرة تاريخية أخرى للمشاركة القبطية في تاريخ مصر. قد يكون من المغري أن ننظر إلى تقلُّبات الحركات السياسية الجارية كتقلبات عنيفة، ولكن على الأقباط الإنجيليين أن يطمئنوا متأكدين أن نصرة الكنيسة كما ذكرت في الكتاب المقدس أكثر من مجرد تقلُّبات تاريخية للمنظمات البشرية السياسية والدول. إن الأحداث الجارية لا تشير إلى نهاية التاريخ ولا إلى هرمجدون. لقد عاشو الأقباط والمسلمون دائمًا وعملوا ووقفوا بجانب مصر دائمًا وبينما كانت تلك العلاقات تعاني من عدم المساواة كثيرًا وتحت ضغط حتى انكسرت، فإن العلاقات لم تنفصم أبدًا. ومن الواضح أن مستقبل الأقباط المسلمين يجب أن يأتي من المصريين ومن الأفكار المصرية نفسها وليس من أفكار مسيحية إسلامية أو حتى أيديولوجيات علمانية من الخارج.
وربما يكون هناك صعوبات فإن التاريخ يذكِّرنا أن الكنيسة عاشت وساهمت دائمًا في المجتمع المصري بطرق متنوِّعة وواسعة وأنها سوف تستمر في عمل ذلك. والسؤال بالنسبة للأقباط الإنجيليين بأي طريق وبمن سوف تفعل هذا؟! PDF
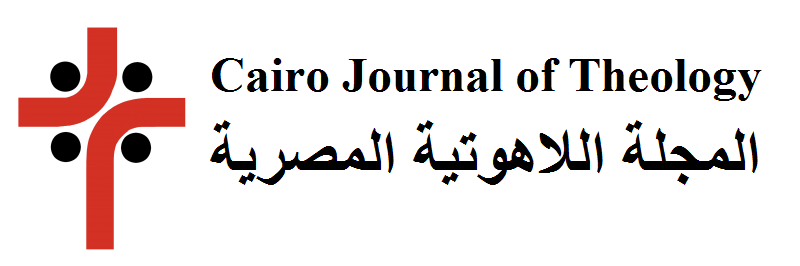



هذا المقال قمت انا بترجمته
This article is translated by Venus Boulos